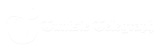كلما داهمتنا الأيام كلما ازداد تشاؤمي وتفاقمت حسرتي على بلادي! لم أعثر منذ 25 جويلية 2021 إلى حدّ الآن على انجاز واحد منصهر في رؤية بعيدة المدى ومنخرط في استراتيجية انقاذ شاملة وواضحة… لم تلفت انتباهي الوطني سوى جملة من الإجراءات المتعثرة، غير المدروسة بعمق يغلب عليها الطابع الانفعالي والارتجالي، عديمة الجدوى آجلا بل وحتى عاجلا.
زادت بلادنا انغماسا في معضلات تكمن خطورتها المتصاعدة في غياب حلول لها. العجز التجاري لا حل له : بلغ 16 ألف مليار دينار ومرشح للوصول إلى 25 ألف مليار دينار إذا تمادى الوضع على ما هو عليه، يتعاظم في كل لحظة جراء عجز الدولة عن محاصرة توريد ما هو ليس من ضرورات البلاد ويُعد بآلاف المليارات وبالعملة الصعبة. التضخم المشبوه ترقيمه لا حلّ له. تهريب الأموال لا حل له : بلغ حجمه من 2011 إلى اليوم 60 مليار دولار (حسب دراسة معهد الأبحاث السياسية والاقتصادية التابع لجامعة Massachusetts الأمريكية)، ما يكفي لتغطية عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وتسديد الديون الخارجية. عجز الميزانية لا حل له. لا أمل يرجى في نسبة نموّ تفوق 6 ٪ في السنوات القادمة وهي النسبة الضرورية الحتمية للخروج بالدولة من حالة التفكك المالي التي هي عليه اليوم. أما قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري وراءه الأستاذ قيس سعيد وجماعته منذ أكثر من سنة فمصادري الموثوق بها أكدت لي أنه لن يرى النور في ما تبقى من السنة الجارية وحتى لو أسعف الصندوق تونس برحمته الواسعة وجاد علينا بأقساط من القرض فلن يسمن ذلك ولن يغني بلادنا من جوع، قطرة من فيض واما مواجهة المحتكرين التي صنع منها الأستاذ قيس سعيد وجماعته حربا استراتيجية وكأن معشر المحتكرين يشكّلون السبب الأصلي والوحيد للهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين لم تجد نفعا لأن للمعضلة أبعادا هيكلية وطنية وامتدادات عالمية. فشل اذن الأستاذ قيس سعيد وجماعته في محاربة المحتكرين رغم أنه يمتلك ترسانة من الإجراءات الجزائية القاسية لصدّهم…
كانت بلادنا في سالف العصر والزمان، أي قبل 2011، أعظم من مشاكلها. كانت عصية على أية معضلة مهما كان هولها وما أكثر ما مرّت به من معضلات طيلة تاريخها، ذلك بفضل ذكاء وفطنة حكامها وثقة شعبها في وطنه. اليوم انقلبت الآية وأصبحت مشاكل تونس أعظم منها! عظمة هذه المشاكل وتراكمها من جهة ورداءة وحمق حكامها من 2011 إلى اليوم من جهة أخرى تبعث فينا هذا اليقين المخجل! لم يخطر ببال تونسي واحد قبل 2011 أن تصبح بلادنا موردة للفسفاط بعدما كانت رابع مصدّر له في العالم، ولا أن تقترض الدولة من البنوك التونسية وبالعملة الصعبة لخلاص ديونها وضمان نفقاتها كدولة ولا أن نشتري – وبالطلوق – السكر من الجارة الجزائرية. أصبحنا اليوم نقترض على 18 سنة لشراء القمح ويقترض ديوان الحبوب على 15 سنة لشراء الحبوب، وفي هذا الصنيع جرم أخلاقي وسياسي متين اذ من سيسدد هذه الديون سوى أجيالنا القادمة المسكينة؟…
انقلبت الأوضاع اذن رأسا على عقب وأصبح شعبنا بكل فئاته – أكرّر بكلّ فئاته حتى الميسورين منه – يسعى اليوم إما للهجرة المنظمة أو لـ “الحرقة”. فقد التونسيون والتونسيات الأمل في تونس لا أكثر ولا أقل. أما الدولة فنراها كالقارب التائه بين أمواج هوجاء لا حول ولا قوة لها عليها، وأما تونس كبلاد فأصبحت محلّ أطماع البعض، ولي في هذا الموضوع مستقبلا حديث وايضاحات (فيديو).
ما عسى أن يحدث إذا عجزت سلطة ما عن وقاية فئات واسعة من شعبها من شبح الجوع وإذا تعنّتت في سياسة الانكار والصمت الجبان والتزوير والجري وراء الرياح، وإذا سرى في نفوس القوم اليأس والقنوط وإذا المواطنة سُئلت بأي ذنب “حرقت” يومئذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها.
الانفجار اليوم في تونس حسابيا وجدليا (من منظور ماركسي للكلمة) منخرط في حتمية التاريخ. التاريخ كالحياة الذي هو مرآة لها خضع منذ بدايته الى جدلية قارة وفاصلة: ما يبلغ حدّه ينقلب إلى ضدّه طال الزمان أم قصر، وتونس بلغت اليوم حدّا من الرداءة في الحوكمة والضياع كدولة ما بعده حدّ. الانفجار حسب رأيي آت وحتمي والسؤال المطروح لا يُشكّك في حدوثه بل فقط في وقت حدوثه…
*** كاتب المقال : عملر صحابو
نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 13 سبتمبر 2022